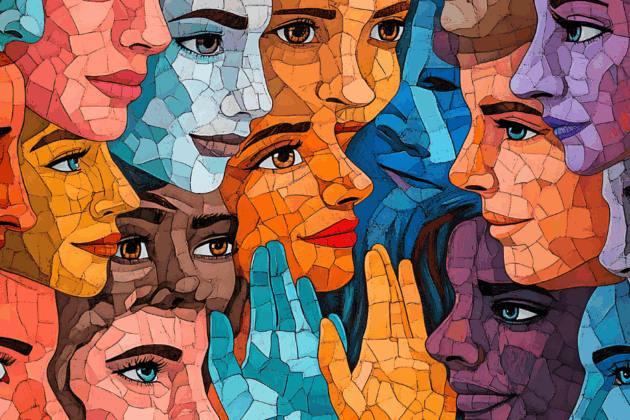تبدو ألمانيا اليوم وطناً بين صورتين متناقضتين. صورة أولى ترسمها السياسة والإعلام كبلد متحفّز تجاه موجات اللجوء، يتجادل برلمانه حول القيود والهويات والحدود. وصورة أخرى تنبض في مسارحها وقاعاتها الأدبية كبلد يحتفي بلاجئين وبأبناء من خلفيات مهاجرة صاروا أصواتاً شعرية وفنية تعبّر بالألمانية عن القلق والمسؤولية والبحث عن المعنى.
لكن مفارقة كبيرة تزداد بين هاتين الصورتين، فبينما تضيّق السياسة خطابها حول “الاندماج”، يوسّع الفن الألماني حدوده ليحتوي وجوهاً جديدة تكتب بالألمانية أو تترجم إلى الألمانية وتفكر بها من خارج “البياض الأوروبي”.
صورة نمطية في الخطاب السياسي
منذ “أزمة اللجوء”، كما يحلو للإعلام الألماني أن يسميها، في 2015، يدور الجدل السياسي في ألمانيا بين “الترحيب الإنساني” و”التحفّظ الأمني”. ورغم تغيّر الحكومات، وتبدّل السياسات، بقيت اللغة السياسية مشبعة بمفردات كالمراقبة والضبط، والرفض أيضاً.
كما يتعامل سياسيوها بمنطق الامتحان مع المبادرات الرسمية التي تعلن دعمها “للاندماج” كاختبار اللغة أو اختبار الولاء. وخلال ذلك، تتقلّص صورة اللاجئ أو المهاجر، لا سيما المسلم، لتصبح نموذجاً جاهزاً في الإعلام. فهو إمّا ضحية تحتاج الرعاية، أو خطر يحتاج السيطرة. وفي كلا الحالتين يعيش في دولة تطلب منه أن “يندمج” لكنها نادراً ما تندمج معه أو تسمح له أن يعبّر عن نفسه.
آيسة إيريم ولينة عطفة.. اللغة الجميلة تطرق القلوب
على مدار أربعة أيام، كانت مدينة كمنتس، عاصمة الثقافة الأوروبية لعام ٢٠٢٥، ملتقىً لمنافسات الشعر باللغة الألمانية. وفيها تفوقت آيسه إيريم، البالغة من العمر ٢٦ عاماً، على ٨٠ متسابقاً في المسابقة الفردية، وحظيت بتصفيق حار من حوالي ١٨٠٠ شخص في قاعة مدينة كمنتس.
آيسة إيريم، الألمانية من أصول تركية والمحجّبة، اختارت إلقاء الشعر لتعلن رفضها للصورة النمطية. وفي نصوصها التي فازت بها ببطولة ألمانيا، تناولت المهندسة المعمارية العنصرية اليومية في ألمانيا والشعور بـ”عدم القدرة على أن تكون أبيضاً بما يكفي”. وباللغة الألمانية ذاتها، تلك اللغة التي يُنظر إليها أحياناً كأداة إقصاء، فحوّلتها هي إلى لغة احتجاج وانتماء في آن واحد.
وقبلها وقفت الشاعرة السورية لينة عطفة على منصة أدبية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، حاملةً لغتها، فلم تتحدث باسم “اللاجئين” بل باسم الإنسان. حصدت بها عدة جوائز في الولاية، لتصبح من أبرز الأصوات الشابة في الأدب الألماني. فقصائدها لا تحمل “اعتذاراً” عن الغربة. وإنما تستعيد الكرامة عبر الجمال. وتكتب عن الحرب والمنفى، وتعتبر ألمانيا وطنها الذي لا يقلّ شرعية عن سوريا.
الثقافة كفعل مقاومة
هذه الأمثلة ليست معزولة وليست حديثة العهد؛ ففي أغلب مسارح الولايات الألمانية ومنها شمال الراين، هامبورغ، برلين وفرانكفورت تكثر المشاريع الفنية التي يقودها أو يشارك فيها لاجئون. ومنها مسرحيات تجمعهم مع ألمان، بنصوصٌ تُكتب بالعربية وتُعرض بالألمانية.
في تلك المساحات، يمارس اللاجئون أو المهاجرون فعل اندماج أعمق من أي دورة لغة ويشاركون في تعريف ما هو “ألماني”. وعلى خشبة المسرح حيث يطرح الجميع أسئلة لا عن الماضي فحسب، بل عن المستقبل المشترك نجد أنفسنا أمام صرح للمواطنة الثقافية.
بين السياسة والثقافة: مَن يغيّر مَن؟
بمثل هذه المشاركات تثبت الثقافة أنها أذكى من السياسة. بل وتستطيع تجاوزها أيضاً. وعلى يد الشعر والمسرح والموسيقى تعيد تعريف حدود الانتماء، لتصبح أكثر إنسانية. وسواء كانوا لاجئين أو من أصول مهاجرة، فهم لا يطلبون قبولاً بقدر ما يقدّمون اعترافاً متبادلاً بأن الانتماء ليس وثيقة إقامة. وإنما فعل مشاركة في صياغة الذاكرة الجمعية.
من الخوف إلى إعادة تشكيل الهوية
تلك الأصوات الثقافية التي تكشف وتدحض ما يُقال عن خوف أوروبا من فقدان ذاتها أمام الهجرة والمهاجرين تستطيع في كل مرة أن تبرهن أن الهجرة ليست تهديداً، بل منجم إبداع يذكّر القارة بأن هويتها الحقيقية لم تكن يوماً نقية. فهي خصبة ومتعددة. وهذا مصدر غناها.